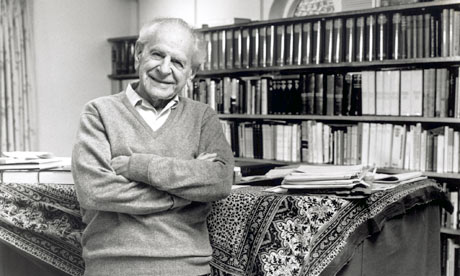د . محمد مجتهد شبستري
( 1 ) الديمقراطية كحاجة للحياة الدينية
القضايا التي نناقشها اليوم كان ينبغي ان تناقش منذ ربع قرن على الاقل . مسائل مثل نوع الحكومة التي نريدها والتنظيم السياسي المناسب لبلدنا هي مسائل اولية ما كان ينبغي ان تترك من دون معالجة جدية حتى اليوم . لو اجرينا مناقشة معمقة ، تحليلية وعقلانية عند تاسيس نظامنا السياسي ، لكان معظم المسائل المثيرة للجدل اليوم قد وجد حلا . لحسن الحظ على اي حال ان هذه المسائل تطرح اليوم ، ومن بينها المسألة التي تناقشها هذه المقالة ، اي "الديمقراطية في مجتمع ديني" .
من المهم تحديد زاوية البحث في سؤال الديمقراطية والديمقراطية الدينية . بديهي ان كل مقاربة للموضوع سوف تعالج جانبا مختلفا عن ذلك الذي تعالجه المقاربات الاخرى . كل مقاربة تنتمي الى اطار علمي مختلف وتستخدم استدلالات ومناهج بحث وزوايا تركيز متمايزة . يمكن مناقشة السؤال من زاوية مفهومية ، فلسفية ، قانونية ، سوسيولوجية ، او سياسية . .الخ .
ربما ظن بعضنا ان سؤال "هل تتلاءم الديمقراطية مع الدين؟" يلخص كل المشكلة ، والحقيقة ان هذا سؤال عن زاوية واحدة من الموضوع فقط . وحتى لو اجبنا عليه فسوف يتوجب معالجة العديد من الاسئلة الاخرى مثل : ما هي الديمقراطية ؟ ، هل نظامنا ديمقراطي ؟ ، هل نحتاج الى الديمقراطية ؟ . كيف نصل الى الديمقراطية ؟ . وهذا يقودنا الى السؤال الذي نحن بصدده ، اي : ماذا يعني وصف الديمقراطية بالدينية ، وهل نتحدث عن ديمقراطية دينية ام ديمقراطية المتدينين ؟ ، وهل يجوز لعامة المسلمين ان يختاروا لانفسهم نظاما سياسيا مثل الديمقراطية ، ام ان الامر متروك لزعمائهم السياسيين والدينيين كي يختاروا النظام المناسب ؟ .
الديمقراطية هي احد المفاهيم الجديدة التي تولدت في اطار المدنية الغربية المعاصرة ، ودخلت حيز النقاش بين المسلمين في السنوات الاخيرة . معظم هذا النقاش يستهدف الحصول على تطمينات حول قدرة الديمقراطية على حل مشكلاتنا ، والتأكد من ملاءمة القيم الديمقراطية لمعتقداتنا الدينية ، اي امكانية اعتبارها خيارا مناسبا لمجتمعاتنا . فيما يتعلق بالتوليف بين الدين والديمقراطية ، ثمة اراء عديدة يدعي بعضها توفر ادلة في النصوص الاسلامية تدعم القيم والمباديء الديمقراطية ، بينما يقتصر الاخر على القول بامكانية الجمع بينهما ، اي وجود فرصة او وسيلة لحل التعارض المحتمل بين الطرفين .
بعض الاسئلة المطروحة في هذا النقاش يعبر عن انشغال ذهني او روحي لعامة الناس ، وبعضها يشغل السياسيين ، او المثقفين او المفكرين وهكذا . ما يشغلني شخصيا هو علاقة هذا السؤال بمعرفتنا الدينية . افترض ان بوسعنا توليف الديمقراطية مع الدين في اطار فهم عقلاني للدين ، وهذا يتوقف على توفر مناهج فهم وتفسير عقلانية . من هنا فسوف اعيد صياغة سؤال العلاقة بين الدين والديمقراطية على النحو التالي : هل لدينا فعلا ، او هل يمكن لنا تطوير فهم جديد للدين قابل لاستيعاب تحديات العصر وتطور الانسان المعاصر ؟ .
الديمقراطية هي سؤال واحد فقط من اسئلة كثيرة مطروحة بالحاح على المسلمين المعاصرين وعلى الفكر الاسلامي ، وبقاؤها مطروحة لزمن طويل يدل صراحة على ان هذا الفكر يفتقر الى منهجية مناسبة لاستيعاب ومعالجة التحديات النظرية وغير النظرية التي تولدت عن تطور الفكر الانساني في العصور الاخيرة . اذا اراد المسلمون ان يردموا الهوة الواسعة التي تفصلهم عن عصرهم ، ويلتحقوا بركب المدنية الحديثة من دون ان يضحوا بايمانهم ، فانهم بحاجة الى ثقافة جديدة قادرة على التسوية بين الدين والمدنية . تأخر المسلمين عن عصرهم هو ثمرة للممانعة التي يجدوتها في قيمهم الدينية ، اي ما يتخيلونه من استحالة الجمع بين ايمانهم من جهة والتقدم العلمي والاجتماعي من جهة اخرى . لكي لا نقع في منزلق التبرير ، فيحب ان نقر صراحة بان ما يفصلنا عن المدنية المعاصرة ليس المسافات ولا مؤامرات الاعداء ، بل عجزنا عن تطوير ارضية ذهنية وثقافية مناسبة تسمح بالتوليف بين متطلبات التقدم ومتطلبات الايمان . سر هذا العجز يكمن في هيمنة مناهج في فهم الدين غير عقلائية ، او غير قادرة على فهم العصر الحاضر وما فيه من قضايا وموضوعات وتحديات .
المنهج السائد في الساحة الدينية ومجامع العلم الشرعي ، منهج متخلف يقود الى تفسيرات للقيم الدينية غير عقلائية ولا يمكن الدفاع عنها . كما ان الكثير مما يسمى اليوم قيما دينية ، ليس دينيا بالمعنى الدقيق ، كثير من هذه القيم ليس وحيا منزلا ، ولا هي تفسيرات قطعية ونهائية للوحي او القواعد الدينية الاصلية . بل تنظيرات لاعراف وتقاليد وسلائق توافق عليها المجتمع او النخبة الدينية في ازمان معينة او ضمن ظروف خاصة باعتبارها ضرورات للنظام الاجتماعي او مصلحة للمؤمنين ، وبناء على هذه الاعتبارات جرى ضمها الى منظومة القيم الدينية ، وترسخت بمرور الزمن وتلقيها بالقبول من جانب اجيال المسلمين او نخبتهم .
نحن نتفهم بطبيعة الحال الاسباب التي قادت الى تلك التفسيرات والظروف التي فرضتها ، فالازمان الماضية التي شهدت ولادتها لم تعرف مثل ما نواجهه اليوم من تحديات فكرية واجتماعية ، ولم يصل اهلها الى المستوى الذي يعرفه انسان هذا العصر من ثقافة وعلم وتكنولوجيا وانفتاح وسرعة . وعلى اي حال فلم تكن المشكلة يومذاك قصرا على المجتمعات الاسلامية ، فالتفكير الديني في مختلف بلاد العالم كان متخلفا او منفصلا عن الحراك العلمي والتطور العقلي الذي اوجد المدنية المعاصرة .
ادى ظهور وتطور العلم الحديث خلال القرون الاربعة الاخيرة الى تقدم هائل في مجال العلوم الانسانية والتجريبية ، تغيرت على اثره حياة الانسان ، كما تغيرت ثقافته وتغير فهمه للعالم . وظهرت في هذا السياق مناهج جديدة للمعرفة والتفسير والتفكير ، تسعى لتمكين الانسان من اعادة فهم ما يجده في عالمه وما ورثه عن اسلافه من تراث وافكار وقيم وتجارب ، ونشير هنا خصوصا الى تبلور مناهج جديدة لفهم النص الديني على اسس عقلانية . ولا شك ان المؤمنين بالاديان قد استفادوا من هذه المناهج . وهذا ما يفسر الميل المتصاعد في عالم اليوم لاستبعاد التفسيرات العرفية او الخرافية للدين . واستطيع القول من دون تحفظ ان توفر العلم والمناهج الفلسفية الحديثة وتطور التجربة العقلية للانسان لم تترك اي مبرر لتلك الشريحة من دارسي العلوم الدينية التي غضت الطرف عما توفره المناهج العلمية الجديدة من امكانات هائلة لفهم وتفسير النص الديني ، وكرست نفسها لحراسة المناهج القديمة التي اكل عليها الدهر وشرب ، وظهر عجزها عن الوفاء بحاجات المسلمين الروحية والدنيوية الراهنة .
كثير من مشكلاتنا الثقافية هي نتاج لترددنا في تطوير مناهج الفهم والاستدلال التي يتعارف عليها العلماء باسم الاستنباط او الاجتهاد ، ولا سيما التردد في الاخذ بالمناهج الجديدة في فهم النص واستنطاق مضمونه . وللاسف فعلى الرغم من توفر هذه المناهج ورغم قدرتنا على تطويرها ، الا ان الاهتمام بهذا الامر في مجامعنا العلمية ضئيل او ربما معدوم . في سنوات الثورة الاسلامية الاولى أتاحت الظروف السريعة التغير مجالا للدعوة الى تجديد الفكر الديني ولاسيما مناهج الاستنباط ، ومساءلة اولئك الذين يتصدون للاجتهاد والفتوى عن منهجهم في البحث ، والمعايير التي يقررون على ضوئها خياراتهم . لكن هذه الدعوة واجهت في كل الاحوال معارضة غير منصفة ، وواجه اصحابها انواعا من العنت حتى اضطروا الى السكوت عنها .
زبدة القول ان الاجابة على سؤال العلاقة بين الديمقراطية والدين يتوقف الى حد كبير على المنهج الذي نتبعه في فهم الدين واستنباط قواعد العمل من نصوصه . وارى انه لا يمكن في ظل المناهج الموروثة التوصل الى جواب مناسب ، لان هذه المناهج ليست مؤهلة من الاساس للتعامل مع اسئلة من هذا النوع . ومن هنا فانه لا الديمقراطية ولا القيم والافكار الاخرى التي انتجتها المدنية المعاصرة ، قابلة للفهم او الملاءمة مع تفكيرنا الديني في ظل تلك المناهج . دعنا على اي حال ننتقل من هذه المقدمة الى مسألة اخرى ، احسبها تمهيدا ضروريا للتفكير في العلاقة بين الدين والديمقراطية ، اعني بها الارضية التي يقوم عليها كل من الطرفين .
قيم الدين وقيم الديمقراطية
حديثنا عن "الديمقراطية" يأخذ بعين الاعتبار كونها مفهوما محددا جرى تعريفه على نحو دقيق من خلال التجربة الفعلية في العالم فضلا عن الابحاث والدراسات في المحافل العلمية المتخصصة . بتعبير اخر فاننا لا نسعى من وراء هذا النقاش الى تخليق مفهوم جديد نطلق عليه اسم "الديمقراطية" ، بل معالجة المفهوم المعروف في العالم وربما تعديل بعض اطرافه بما لا يؤثر على قوامه الاساسي والمباديء الكبرى التي تمثل جوهره . بالنظر لتطورها في محيط معرفي مختلف فان "القيم الديمقراطية" هي تركيب منظومي متمايز عن "القيم الدينية" التي تمثل هي الاخرى تركيبا منظوميا خاصا وقائما على ارضية مختلفة عن تلك التي تقوم عليها القيم الديمقراطية . من ابرز موارد الاختلاف بين المنظومتين على سبيل المثال ، هو ان قيم الديمقراطية تمثل قيما توافقية- ضمنية ، بمعنى انها ثمرة لنوع من التوافق الاجتماعي على معناها ومؤدياتها . وفي الحقيقة فان معظم القيم الديمقراطية – فوق قيامها على التوافق – تستهدف ايضا تعزيز وتعميق علاقات التوافق والتعاقد بين الافراد . من بين القيم التي يظهر فيها كلا البعدين مثلا اصالة التعاقد ، الرضا والقبول الشعبي كمصدر للشرعية ، المساواة المدنية ، حق الفرد في الاختيار المستقل لنمط حياته الاجتماعية والسياسية ، سيادة القانون ، ارتباط الحقوق الدستورية بالمواطنة ، ضمان حقوق الانسان ، حاكمية الشعب . الخ . هذه المفاهيم تنطوي في داخلها على محتوى قيمي – توجيهي ، ومن هنا فان تفعيلها في الحياة العامة هو الذي يعطي للديمقراطية شكلها ومضمونها الخاص .
لا اريد الان الدخول في بحث حول الارضية الفلسفية او الاخلاقية لتلك المفاهيم ، وما اذا كانت مستمدة من القانون الطبيعي او الفطرة او غير ذلك من المصادر . الامر المسلم به هو ان تلك القيم قد حصلت على مكانتها الرفيعة نتيجة لـ "توافق" اعضاء المجتمع على معياريتها ، بعبارة اخرى فان اعضاء مجتمع ما قد "توافقوا" على هذه القيم و "تعاقدوا" على جعلها اساسا للقانون الذي يحكم حياتهم . تحول هذه القيم النظرية الى معايير حاكمة ومنظمة للعلاقات الاجتماعية هو اذن نتيجة للتوافق والتعاقد بين اعضاء الجماعة ، وليس بفرض او الزام من جانب احدهم او من جانب قوة خارجية فوقهم . من هنا فان الخطوة الاولى التي تمهد لقيام حكومة ديمقراطية ، هو توفر هذا النوع من التوافقات (او القيم الديمقراطية) بين الشعب .
لم يكن توصل المجتمعات الديمقراطية الى تلك التوافقات ثمرة للتامل الفكري المجرد ، بل نتيجة لتحولات في الحياة الاجتماعية واحيانا ازمات طاحنة اوجبت على الناس التفكير في بدائل ومخارج من تلك الازمات . ومن هنا يمكن القول ان ظهور هذا النوع من التوافقات والقيم ، وقبول الناس بها وتعايشهم مع مستلزماتها ، يتطلب تحولات من نوع ما ، اقتصادية او سياسية او ثقافية ، توفر ما يمكن وصفه بتمهيد نفسي او ذهني يسهل على اعضاء المجتمع القبول بمبدأ التوافق كوسيلة قطعية ووحيدة لحل الخلافات والتعارضات في المصالح وادارة الموارد والثروات الطبيعية المشتركة ، ثم الانتقال الى مرحلة التعاقد بين افراده على صورة النظام السياسي الذي يأملون العيش في ظله .
من الممكن بطبيعة الحال ان يعيش الناس من دون هذه القيم . من الممكن مثلا ان يعيش الناس في مجتمع لا يعرف مفهوم المواطنة وما يترتب عليها من حقوق دستورية ، او لا يعرف مفهوم الارادة العامة ، او حقوق الانسان ، او التمييز بين المجال الشخصي والعام ، الخ . . من الانصاف ايضا القول بانه لا يمكن البرهنة باي طريقة فلسفية او تاريخية او غيرها على ان المجتمعات التي لم تتوصل الى تلك التوافقات والقيم ، كانت على خطأ او كانت سيئة او غير متحضرة او غير طبيعية ، او ان حياة الناس فيها كانت خالية من المعاني الانسانية . واقع الامر ان التحولات الاجتماعية والعلمية قد وضعت امام الناس حقائق جديدة على مستوى المعرفة او على مستوى السياسة والاقتصاد ، اي حقائق ذهنية وحقائق مادية . ونتيجة لتعرف الناس على تلك الحقائق ، توصلوا الى قناعة ضمنية او صريحة بان الاخذ بالقيم والمفاهيم الديمقراطية المذكورة اعلاه سوف يجعل حياتهم اكثر انسانية .
خلافا لهذا المعنى فان القيم الدينية ليست توافقية ، اي ان اعتبارها الديني والاخلاقي ليس منبعثا من اتفاق الجماعة على دينيتها او معياريتها . الدين ليس من ذلك النوع من سبل الحياة الذي يتوافق اعضاء المجتمع على صناعة مضمونه او منحه القيمة المعيارية . ربما يقول بعضنا بان القيم الدينية يمكن ان تتولد بصورة من الصور من تجربة روحية . ونقصد بالتجربة هنا معناها العرفاني وليس المادي . التجربة بالمعنى المادي قد تنحصر في ممارسة الشعائر ومظاهر السلوك اليومي التي يقوم بها كل المتدينين . اما المعنى العرفاني الذي يتحدث عنه الفلاسفة والعارفون ، فهو يشير الى نوع خاص من التفاعل بين الانسان والكون ينبعث من وحدة الاصل الذي يرجع اليه الطرفان . هذا التفاعل ينتج معرفة وعلاقة بين داخل الانسان وخارجه ، بينه وبين النظام الكوني الذي يعيش فيه ، وهو قريب من معنى الفطرة الى حد ما . وعليه فاذا كان منشأ الدين هو هذا النوع من التجربة الروحية ، فانه يمكن ان يكون ايضا منشأ للقيم الدينية . لكن حتى لو قلنا بهذا المنشأ للدين او القيم الدينية ، فانه لا يمكن ان يكون من نوع المفاهيم التوافقية ، فالتجربة الروحية بهذا المعنى هي – بالضرورة - تجربة فردية لا يمكن للانسان ان يشرك فيها غيره بل ولا يمكن ان تكون مشتركة مع الغير .
يتميز الدين عن سائر الممارسات الحياتية الاخرى بانطوائه على جانب قدسي هو مصدر فعال للالزام ، بمعنى ان الايمان بذاته يولد في داخل النفس معنى خاصا للافعال ، ويترتب عليه شعور عند المؤمن بان عملا ما هو واجب يلزمه القيام به ، وان عملا اخر ينبغي اجتنابه . القبول بالايمان ومقتضياته وممارستها من جانب الفرد ، تشكل ما يمكن وصفه بتجربة دينية بالمعنى العام للكلمة ، فهي تولد قيما او تسبغ قيمة على اشياء ، وتسلبها من اخرى ، فهي مثلا تلقي رداء القداسة على اماكن او اعمال او اشخاص او كلام ، فتجعلها ذات قيمة استثنائية . توليد هذه القيم لا يجري نتيجة لتوافق اجتماعي كما هو واضح ، بل من خلال علاقة مباشرة بين الفرد وبين المصدر الاعلى الذي ينتسب اليه دينه ، اي من خلال تجربة روحية فردية .
زبدة القول اذن ان الديمقراطية هي منظومة قيمية تقوم على ارضية التوافق الاجتماعي ، فالارادة العامة للمجتمع هي مصدر شرعيتها ومعياريتها . خلافا لهذا فان القيم الدينية مستمدة من الايمان الديني ، وهو ليس قائما على توافق بين الناس ، بل ثمرة للاتصال بين الفرد وربه . حتى لو قلنا بان الدين هو تجربة روحية ، فانها ايضا لا تخرج عن ذلك الوصف ، ذلك ان التجربة الروحية هي في نهاية المطاف تجربة فردية وليست موضوعا للتوافق .
الديمقراطية كضرورة للحياة الدينية
فيما يتعلق بالتركيب المفهومي "الديمقراطية الدينية" يمكننا تصور معنيين للوصف الديني :
المعنى الاول : ان الديمقراطية الدينية هي اطار يضم في داخله منظومة من القيم الدينية ، اي ان المحتوى القيمي والاخلاقي للديمقراطية هو امتداد للنص الديني او للتجربة الدينية . اذا كان هذا المعنى هو الصحيح فان وصف الديني هو قيد للديمقراطية وليس شرحا عليها . وبالتالي فان اهمية الديمقراطية او قيمتها تنبع من كونها تكليفا دينيا . كما ان قبول المؤمن بها راجع الى ورودها في النص الديني او ارتباطها بالتجربة الدينية .
المعنى الثاني : ان الديمقراطية التي نتحدث عنها (الدينية) هي ذات الديمقراطية المعروفة في العالم من دون ان نتدخل او نغير في مفهومها . اي انها غير مستنبطة من النص الديني وليست موضوعا للاجتهاد والاستنباط على النحو المتعارف اليوم في الحوزة العلمية وغيرها من مجامع العلم الشرعي . مفاد هذا القول انه لا يمكن الحصول على قيم الديمقراطية في الكتاب والسنة او سيرة المعصومين ولا يمكن تاسيس شرعيتها او معياريتها على هذا الاساس . وبالتالي فان الاقتناع بها او التعويل عليها لا يستند الى آية في القرآن او رواية من المأثورات او عملا مسجلا كسيرة للمعصوم .
في رأينا ان المعنى الثاني هو الصحيح . لكن يجب الانتباه الى ان عدم الاشارة الى القيم الديمقراطية في التراث الديني لا يعني ابدا انها مقولة باطلة او مضادة للدين . فورود مفهوم ما في التراث يرتبط بالظرف الزمني والموضوعي الذي شهد ولادة ذلك التراث . بديهي ان المفاهيم والافكار الجديدة ومن بينها الديمقراطية لم تكن سؤالا مطروحا في الزمن الذي نعتبره مرجعيا ، اي زمن حضور المعصوم . وقد اشرنا في السطور السابقة الى ان ظهور قيم الديمقراطية وامثالها من القيم التوافقية رهن بتحولات خاصة في حياة المجتمعات ، وما لم تتحقق هذه التحولات البنيوية فان ظهور تلك القيم ، وخصوصا تحولها الى ضرورة للحياة ، هو امر مستبعد . نعلم ايضا ان مجتمع المسلمين لم يتعرض خلال العصور السابقة التي نرجع اليها في دراسة النصوص الدينية ، لتلك التحولات التي اثرت في وعي الانسان . نحن نعيش اليوم في عالم جديد ، ولدت فيه الكثير من المفاهيم الجديدة ، كما تغيرت كثير من المفاهيم المعروفة سابقا . انظر مثلا الى مفهوم "الدولة" المعاصر وكيف انه مختلف تماما عن مفهومه المتداول في كتب التراث ، وانظر ايضا الى مفهوم القانون ، المواطنة ، حاكمية الشعب ... الخ . هذه المفاهيم وامثالها لم تكن موجودة او معروفة في نظامنا الاجتماعي وثقافتنا السائدة قبل العصور الحديثة . هذه مفاهيم جديدة للحياة الانسانية وعلينا ان نسعى لفهمها ونقدها وتنسيجها في نظامنا الثقافي . اما البحث عن نظائرها في كتب التراث او في تجربة المسلمين الاوائل فهو عمل لا طائل تحته ، لانها بذاتها لم تكن موجودة او ان موضوعاتها لم تكن مطروحة فيما سبق .
السؤال الذي يواجهنا عند هذه النقطة هو : اذا لم يكن ممكنا العثور على دليل يدعم الديمقراطية في النصوص الدينية ، فهل ثمة مرجعية بديلة يمكن الاستناد اليها في الاخذ بالنظام الديمقراطي؟ . بعبارة اخرى كيف نتصور ديمقراطية دينية دون ان يكون لها مرجعية في النص الديني ؟ .
للجواب على هذا السؤال نحن بحاجة الى التفسير العقلاني للدين الذي سبق الحديث عنه . صحيح انه لا يمكن التوصل الى مرجعية دينية للديمقراطية بالاعتماد على منهج الاجتهاد والاستنباط الموروث ، لكن يمكن العودة الى القيم الدينية والى روح الدين بشكل عام للبرهنة على انه لا يوجد تعارض بين الدين والديمقراطية ، بمعنى انه يمكن لنا ان ناخذ بالنظام الديمقراطي دون ان نخسر ايماننا ، بل يمكن البرهنة على ان الاخذ بالديمقراطية سوف يجعل تطبيق مقتضيات الايمان اكثر يسرا واقرب منالا . المشكلة اذن لا تتعلق بقابلية الدين او الديمقراطية للتلاؤم مع بعضهما ، بل بالمنهج المتبع في فهم وتفسير الدين .
نحن بحاجة الى رصد راسمال كبير في مناقشة هذه المقولات ، فمن دون الانخراط في بحث عميق ومتعدد الابعاد فان مشكلات مثل ما نحن بصدده (اي ما هي الديمقراطية الدينية) لن تكون قابلة للحل . اذا تحدثنا عن الاصلاح في امثال مجتمعنا ، فلا شك ان الافكار الاصلاحية لا يمكن ان تصل الى نتيجة من دون بحوث عقلانية معمقة ومتواصلة في النص الديني وتفسيره .
يجدر الاشارة هنا الى ان مجتمعنا ليس الوحيد الذي تثار فيه هذه الاسئلة او تظهر في صفوفه الحاجة الى مثل هذا البحث . فهي مطروحة حتى في المجتمعات الغربية التي قطعت شوطا بعيدا في الاصلاح السياسي . بالنسبة للمؤسسات الدينية المسيحية مثلا ، نشير الى ان الفاتيكان كان حتى منتصف الستينات من القرن العشرين يتخذ موقفا مرتابا واحيانا معاديا لمواثيق حقوق الانسان الدولية باعتبارها نقيضا للمسيحية . لكنه اقتنع منذ العام 1964 بان اعتماد هذه المواثيق يوفر فرصة افضل للتدين والايمان . الاستدلال الذي جرى الاخذ به يومئذ هو ان هذه المواثيق تعين لكل انسان حريما لا يمكن تجاوزه من جانب اي سلطة ، ويضم هذا الحريم منظومة من الحريات الطبيعية التي ترتبط بانسانية الانسان ، وابرزها حرية الاعتقاد والعبادة وحرية التفكير والعمل الخ . اذا تمتع كل انسان بهذا الحريم فانه – كمتدين ، سواء كان مسيحيا او غيره - يمكن ان يعيش حياته الدينية ويمارس مقتضيات ايمانه بحرية وأمان . ومن هنا فان اي نظام سياسي يحترم حقوق الانسان هو بالضرورة اكثر انسانية واقرب الى جوهر الدين من اي نظام قاهر او شمولي لا يقيم حرمة لحياة الافراد الشخصية ولا يحترم حقوقهم .
حسنا ، لو اتبعنا هذه الطريقة التجريبية في الاستدلال ، فهل ستوصلنا الى توليف مناسب بين الدين والديمقراطية ؟ .
دعنا نفترض ان المسلمين وجهوا هذا السؤال لانفسهم : ما هو ظرف الحياة الاكثر تناسبا مع هويتنا كمسلمين ، العيش في ظل حكومة ديمقراطية ام العيش في ظل حكومة استبدادية او شمولية؟ .
يمكن صياغة هذا السؤال على نحو آخر : ما هو نوع النظام السياسي – الاجتماعي الذي يوفر فرصة اكبر لنا كي نعيش في انسجام مع ايماننا ومعتقداتنا وقيمنا الدينية ، هل هو النظام الديمقراطي ام الاستبداد ؟ .
نفترض ان كل عاقل سيفضل – بصورة مبدئية على الاقل - الديمقراطية على الاستبداد . اذا اخذنا بهذه الرؤية فلن يكون ثمة حاجة الى تغيير في محتوى مفهوم الديمقراطية او استبدال القيم التي يقوم على اساسها او يسعى الى ترسيخها . من ناحية اخرى فان هذه الرؤية لا تأخذ بالديمقراطية من منطلق الانفلات من حدود الدين واحكامه . على العكس من ذلك فاننا نطرح ذلك السؤال ، وناخذ بهذه الرؤية انطلاقا من كوننا مسلمين مؤمنين ، نريد ان نعيش حياتنا من دون ان نتخلى عن ايماننا . ولهذا فان سؤالنا يدور في جوهره حول البيئة التي توفر فرصة اكبر وافضل للعيش كمؤمنين . رؤيتنا تقول ان القبول التوافقي بقيم الديمقراطية واقامة الحكومة التي تجسدها ، سوف يوفر ظرفا افضل للاعتقاد الحر والممارسة الحرة لمقتضيات الايمان ، ومن هنا فان هذا النظام اكثر انسانية كما انه اكثر دينية من اي نظام استبدادي .
الاخذ بالديمقراطية وتفضيلها على ما سواها ينطلق اذن من مبررات دينية بحتة . لكن هذا ليس نهاية القصة . فالنظام الديمقراطي يوفر - اضافة الى ما سبق - فرصا لتحقيق اغراض الدين واهدافه . من الامور البديهية عندنا ان الدين يسعى الى محو الظلم والقهر وترسيخ العدالة الاجتماعية باعتبارها اهدافا اولية لاي مجتمع ديني . وينظر الى هذه الاغراض كمسؤولية مشتركة يساهم في انجازها جميع الناس . يريد الدين ايضا ان يؤمن به الناس مختارين لا مضطرين او مجبرين ، وان يعيشوا احرارا في دنياهم غير مرتهنين او مقموعين ، لان الحرية هي البيئة التي يزدهر فيها الايمان وتتبلور فيها الطاقات الانسانية ، وتتقدم الحياة . هذه الاغراض هي بعض الثمرات النسبية لنظام ديمقراطي ، ولهذا فان قبولنا بمثل هذا النظام ينطلق من ايماننا الديني ، وهو مبرر على ارضيته . نقبل بالديمقراطية لانها تمكننا من تحقيق الاغراض التي يسعى اليها الدين ونريد تحقيقها كمؤمنين .
ليس ثمة تناقض بين ان نكون مسلمين وان نستعير نظاما حياتيا تبلور خارج اطار الاسلام . في الماضي فعل المسلمون الشيء نفسه واستعاروا انظمة حياة تبلورت خارج اطارهم لانهم وجدوها اكثر تناسبا مع اسلامهم ومع نوعية الحياة التي يريدون ان يحيوها كمسلمين .
من الواضح ان قبول الديمقراطية بالاستناد الى قيم دينية توافقية وتنسيجها ضمن ثقافة المسلمين يستوجب مراجعة وتعديل نظام القيم الخاص بالثقافة الاسلامية لتمكينها من استيعاب القيم الجديدة وهضمها وادراجها ضمن منظوماتها القيمية الخاصة . من ذلك مثلا موقفنا من القهر والعنف ، اذ ليس من المعقول ان تندرج قيم الديمقراطية في نظامنا الثقافي بينما لا نزال نروج للعنف وفرض الاراء والقناعات بالقوة والقهر ونلقي عليها اوصافا قيمية او دينية من نوع اعتبارها امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر او جهادا في سبيل الله ، لايمكن ان نقدس الجبر والقهر ونستوعب الديمقراطية في الوقت نفسه . هذا لا يعني بطبيعة الحال التخلي عن المباديء الاسلامية مثل الجهاد او الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل التخلي عن استخدام مثل هذه المباديء في القهر والتجبر او ممارستهما بطريقة تحتوي على قهر او عنف ، مثل قمع حرية التعبير او منع الافراد من ممارسة شعائر او انماط حياة تخالف السياسات الرسمية . اول شروط الديمقراطية هو الاعتراف بالمجال الخاص للانسان الذي هو حريم شخصي لا سلطة للدولة فيه ، ولا يجوز خرقه من جانب اي طرف .
ليس من العسير على اي مجتمع ان يراجع منظوماته القيمية . في الحقيقة فان هذه العملية تجري في كل الاوقات في كل مجتمع . الناس يتفاعلون مع التحولات التي تجري في حياتهم ومن حولهم ، كما يتفاعلون مع التحديات التي تواجههم ، فيغيرون اراءهم وقناعاتهم ، اي يستبدلون قيما قائمة باخرى جديدة من اجل تحسين كفاءة نظامهم الاجتماعي وتحسين مستوى معبشتهم ، وهكذا تجري الامور على الدوام ، وبصورة عفوية في الغالب . القيم الدينية التي نتحدث عنها ولدت قبل اربعة عشر قرنا ، لكنها تعرضت طوال هذه الفترة لمراجعات عديدة حتى وصلت الينا على الصورة التي نعرفها اليوم ، وهي صورة تختلف قطعا عما كانت عليه قبل قرون . لا يوجد اي مانع شرعي او عقلي يحول دون مراجعة القيم التي نرجع اليها في تنظيم حياتنا ، بل يمكن القول ان هذا هو موطن الاجتهاد في معناه الدقيق .
لو نظرنا الى ثقافتنا السائدة وما ينطوي عليه تراثنا ، نظرة نقدية ، فسوف نجد الكثير مما يحتاج الى اصلاح في نظامنا القيمي وفي اعرافنا وتقاليدنا . هناك على سبيل المثال تمييز بين الناس وتصنيف لهم كمواطنين من الدرجة الاولى والثانية . ثمة طبقات او اصناف اجتماعية تعتبر نفسها ممتازة على غيرها ، وتحسب لنفسها حقوقا على الاخرين ، وهذا بطبيعة الحال خلاف اصل التكافؤ والتساوي بين بني الانسان . هذه القيم وامثالها تحتاج الى اصلاح يقود الى الاقرار بالتكافؤ التام بين الناس والمساواة المدنية بينهم كمواطنين اكفاء لبعضهم . لا يمكن اغفال هذه العيوب في نظامنا الثقافي لان التغافل لا يحل اي مشكلة .
زبدة القول اذن ان التوليف بين الدين والديمقراطية ليس بالامر العسير . لكنه مشروط بالنظر في الاسلام ، في روحه وفي قيمه ، وانتهاج منهج عقلاني انساني في فهمه وتفسيره . وهذا يتطلب بالضرورة عدم الاقتصار على اراء الفقهاء ، وعدم الاخذ بمنهج الاجتهاد والاستنباط الموروث . ان رؤية جديدة وانسانية للدين سوف تمكننا من بسط ارضية فكرية وقيمية دينية جديدة تستوعب التحديات الفكرية والحياتية التي تتجه الينا . نحن في امس الحاجة الى هذه الارضية كي نعيش عصرنا ونحافظ على ايماننا في الوقت ذاته .
بقية فصول الكتاب
1) الديمقراطية كحاجة للحياة الدينية محمد مجتهد شبستري
http://talsaif.blogspot.com/2011/10/blog-post_8707.html
http://talsaif.blogspot.com/2011/10/blog-post_8707.html
2) الديمقراطية والديمقراطية الدينية : المباديء الاساسية محسن كديور
http://talsaif.blogspot.com/2011/10/blog-post_9060.html
http://talsaif.blogspot.com/2011/10/blog-post_9060.html
3) الديمقراطية الدينية: حاكمية العقل الجمعي وحقوق الانسان عبد الكريم سروش
http://talsaif.blogspot.com/2011/10/blog-post_6931.html
http://talsaif.blogspot.com/2011/10/blog-post_6931.html
4) من المدينة الفاضلة الى مدينة الانسان :
الفرضيات الاولية لبحث الديمقراطية الدينية علي رضا علوي تبار
http://talsaif.blogspot.com/2011/10/blog-post_7868.html
http://talsaif.blogspot.com/2011/10/blog-post_7868.html