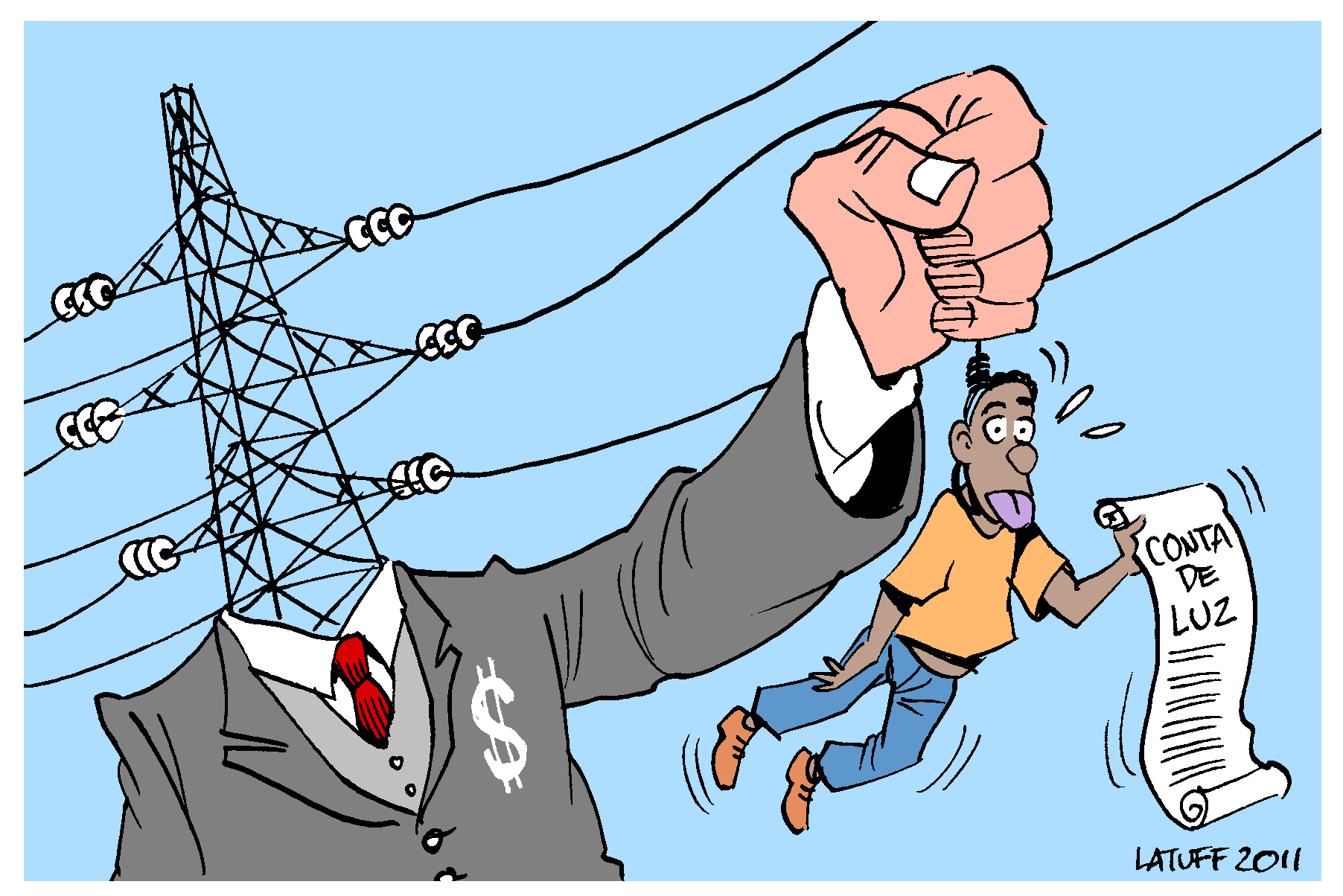وعلى رغم منطقية التبرير ،
فلا زلت مترددا في قبول محصلته ، وهو اذا صح في بعض المدارس ، فلا ينبغي ان يكون
صورة عن الوضع الاعتيادي في جميعها .
وعلى رغم منطقية التبرير ،
فلا زلت مترددا في قبول محصلته ، وهو اذا صح في بعض المدارس ، فلا ينبغي ان يكون
صورة عن الوضع الاعتيادي في جميعها .مدونة توفيق السيف . . Tawfiq Alsaif Blog فكر سياسي . . دين . . تجديد . . . . . . . . . راسلني: talsaif@yahoo.com
10/09/1998
المدرسة ومكارم الاخلاق
 وعلى رغم منطقية التبرير ،
فلا زلت مترددا في قبول محصلته ، وهو اذا صح في بعض المدارس ، فلا ينبغي ان يكون
صورة عن الوضع الاعتيادي في جميعها .
وعلى رغم منطقية التبرير ،
فلا زلت مترددا في قبول محصلته ، وهو اذا صح في بعض المدارس ، فلا ينبغي ان يكون
صورة عن الوضع الاعتيادي في جميعها .03/09/1998
العودة الى المدرسة
27/08/1998
الفكرة وصاحب الفكرة
ليس من واجبات
الكاتب ان يقول للناس ما يحبون ، والا كان حديثه اعلانا عن نفسه ، لا دعوة الى
الفكرة ، والاصل ان المهمة الكبرى للكتاب والمثقفين ، هي دعوة الناس الى تبني
الافكار أو المواقف التي يظنونها صحيحة ، ولهذا قال اهل العلم في سالف الزمان ، ان
العلم حجة على صاحبه ، كما ان الدعوة اليه وظيفة ، يقوم بها شكرا لله الذي انعم
عليه بهذا القدر من المعرفة .
بناء على هذا ، فقد يظن الكاتب نفسه قادرا على قول ما يشاء حين يشاء ، لكن الفرق عظيم بين الحقيقة والواقع ، فما هو صحيح قد لا يكون ممكنا ، وما هو ممكن قد لا يكون صحيحا ، وقد يجد الكاتب نفسه مخيرا بين السكوت ، أو التحول الى رجل علاقات عامة ، يقول للناس ما يرغبون في سماعه ، بدل اخبارهم بما ينبغي لهم معرفته ، البديل الصحيح هو التسلح بالقدر الممكن من الشجاعة لقول ما يراه صحيحا ، ان كان الامر يستحق العناء ، أو كان العناء قابلا للتحمل.
لو سألت الناس عن الكاتب الذي يفضلونه ، فسيخبرك معظمهم ـ إذا لم نقل جميعهم ، بانهم يريدون كاتبا يتحدث بصراحة وتجرد ، ولعلهم يغتنمون الفرصة لذم كتاب العلاقات العامة ، الذين يفصلون المادة على مقاس الشخص الذي يتوجه اليه الخطاب ، لكن إذا تعلق الامر باشخاصهم ، فان هؤلاء الناس انفسهم ، لا يرغبون في كاتب يقول لهم ما لا يعجبهم ، أي ما لا يتفق مع رأيهم الحاضر أو مصلحتهم الراهنة أو ميولهم .
ويبدو لي ان هذا
هو الامر الطبيعي ، فكل انسان يريد من الآخرين ان يكونوا موضوعيين ومنصفين ، شرط
ان لا تؤدي تلك الموضوعية وهذا الانصاف ، الى الاضرار به أو ايذاء مشاعره ، وعلى
أي حال فلكل انسان الحق في ان يحمي مصالحه وما يراه من حقوقه ، وله الحق في ان
يدافع عن آرائه ، بعض النظر عن مواقف الاخرين ومصالحهم ، فاولئك ايضا لن يقفوا
مكتوفي اليدين إذا اقتربت النار من خبزهم .
اقول ان هذه
ممارسات مقبولة ، ينبغي تفهم ما يترتب عليها ، ولو كان غير مريح ، لكن من ناحية
ثانية فان الافراط في التمسك بالاراء والمواقف ، ولا سيما الضجر من آراء الاخرين
المخالفة ، يجعل الانسان معزولا عن محيطه الثقافي ، ويحرمه من ثمرات التفاعل مع
اراء الغير وحاصل عقولهم ، وخير للانسان ان يتحمل اذية الخلاف البسيطة من ان يبقى
اسيرا للجهل .
ويكره الناس ان
يوصفوا بالجمود والانغلاق والعاطفية ، ويحبون ان يوصفوا بالمرونة والانفتاح
والعقلانية ، لكن الى أي حد يا ترى يستطيعون تلبية المتطلبات النفسية والسلوكية ،
التي تؤهلهم للاتصاف بتلك الاوصاف المرغوبة ؟ .
الجمود يعني
التمسك بالاراء والافكار المعتادة ، ومقاومة أي محاولة لتغييرها او تعديلها ،
والانغلاق هو اقامة جدار بين الذات والاخرين ، يمنع وصول اراءهم وتاثيرهم ، هذا
الجدار عبارة عن تصنيفات مسبقة لكل شخص ، تجعل افكاره موصومة ومعيبة ، قبل ان يكلف
المتلقي نفسه عناء البحث فيها او تحليلها ، اما العاطفية فهي بناء الاراء والمواقف
على اساس قرب الموضوع من الذات وبعده عنها ، لا على اساس مقومات الموضوع ،
والقواعد العقلانية والمفاهيمية ، التي يسميها اهل العلم (بناء العقلاء) والتي يشترك
في الايمان بها كل ذوي العقول .
وعلى العكس من هذا
فان الانفتاح والمرونة والعقلانية ، هي الاستماع الى الاراء المختلفة ، بغض النظر
عن الموقف النهائي منها ، ثم الاخذ بعين الاعتبار احتمال ان تكون صحيحة حتى لو
خالفت ما هو مقبول سلفا لدى الشخص المعني ، فالانسان المنفتح يقبل بالاستماع الى
الاراء المختلفة بغض النظر عن الموقف النهائي منها ، ويعلم ايضا ان الزمن فعال
سلبا وايجابا في المعلومات والافكار ، معلوماته ومعلومات الاخرين ، افكاره وافكار
الاخرين .
لكي تنطبق صفة
الموضوعية والانفتاح والمرونة على شخص ، فانه مطالب باحتمال مخالفة الغير لارائه ،
ومطالب باحتمال التخلي عن بعض هذه الاراء ، أي التخلص من الاعجاب بالذات ، الذي
يضفي على المتبنيات الذاتية نوعا من العصمة والمصونية من التغيير والتعديل ،
فالعاقل لا يرفض فكرة دون تمحيصها ، ولا يرفض فكرة لأنه يبغض صاحبها ، ولا يشكك في
فكرة لانها دارت حول موضوع ثقيل على نفسه ، او ارتبطت شواهدها بمواقف تباين ما
يميل اليه ، وقد ورد في الاثر عن نبي الله عيسى عليه السلام ان الحكمة كالجوهرة
تؤخذ ولو كانت في فم الكلب .
كما تحترم افكارك
فان الاخرين يحترمون افكارهم ، ومثلما تتوقع من الغير ان يقبل بارائك فان اولئك
يتوقعون منك موقفا مماثلا ، ولو ان كل الناس اختاروا التمسك بآرائهم ، وطرح ما
يقوله الاخرون ، لما قام للعلم بنيان ، ولما تطورت معارف البشرية ، ينبغي للعاقل
ان يعامل الناس بمثل ما يحب من المعاملة ، فاذا ارادهم ان يقبلوا بما عنده ، فلا
بد له ان يقبل بعض ما عندهم ، والا كان من المطففين الذين توعدهم القرآن بالويل ،
لانهم (اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) .
الموضوعية
والعقلانية هي ان تقول الحق ولو كان مرا ، وتقوله ولو كان خلاف ما ترغب ، وتقوله
ولو انتهى الى قناة من لا تحب ، فالحق مجرد في ذاته ، لا يتكيف بحسب الميول
والرغبات ، والموضوعية تقتضي النظر في أبعاد الموضوع ذاته ، دون قياس للمسافة التي
تفصله عن المتبنيات الشخصية .
يستطيع الكاتب ان
يقول للناس ما يحبون ، لكنه لن يكون صادقا معهم ولا امينا ، ويستطيع ان يتحول الى
كاتب عرائض يكيل الأوصاف بحسب المناسبة ، لكنه لن يكون صادقا مع نفسه .
الى جانب هذا فهو يستطيع احيانا قول ما يؤمن به
، والتعبير عما يعجز الاخرون عن التعبير عنه ، بعض الحقيقة ليست زيفا ، فهي القدر
المستطاع ، فان قدر على الحقيقة كلها ، وجب عليه اظهارها ، وان عجز عنها كلها ،
فخير له ان يعتصم بالصمت كي يريح ويستريح ، فليس اسوأ من قتل الحقيقة غير تزييفها
.
نحن بحاجة الى
توسيع مساحة التعبير ، بحاجة الى فضاء يخلو من العقبات التي تجعل الكاتب عاجزا ،
نحن بحاجة الى ان نحتمل بعضنا ، وان نسمع اراء بعضنا ولو خالفت اراءنا او اضرت
بمشاعرنا ، ذلك هو السبيل الوحيد الذي اذا سلكه الناس ارتقت معارفهم واصبح للعلم
شأن ومكان .
عكاظ 27 اغسطس
1998
09/07/1998
حـديـث النــــــــاس
03/07/1998
وجوه الاستمتاع بالقوة العسكرية
رحلة البحث عن الذات
قلت في الاسبوع الماضي ان كتاب الاستاذ اياد مدني " حكاية سعودية " ليس سيرة ذاتية بالمعنى الدقيق ، وان بدا هكذا. وسألت نفسي حينئذ...